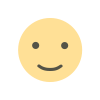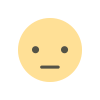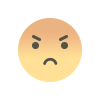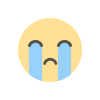نسيان الماضي أم مصادقته؟ الطريق الوعر نحو التصالح مع الذات
في زوايا الفلسفة وتحت ضوء التجربة الإنسانية، تقف علاقتنا بالماضي كعلامة استفهام مفتوحة: هل نحن عبيد لذاكرتنا؟ أم سادة على ما نُبقيه منها وننساه؟ في هذا المقال سنتناول المفاهيم النفسية والفلسفية العميقة المرتبطة بالذاكرة، النسيان، والشفاء من تجارب الماضي. نحلل آراء كبار الفلاسفة، ونُعيد التفكير في الطريقة التي نتعامل بها مع الألم والذكريات والصدمات؛ لا بهدف الحنين أو النكران، بل لفهم أعمق لكيفية صوغ الذات من خلال ما كان.

كان لإيمانويل كانط خادمٌ يُدعى مارتن لامبه، أودعه — على شدة ما عُرف عنه من صرامة الطبع وجفاف السلوك — شيئًا من المودة والرعاية. وكان، وهو الفيلسوف الذي جعل من الواجب الأخلاقي شريعةً عقلية لا تُفارقه، أربعون عامًا تعاقبت، تواشجت خلالها حياتا الرجلين: كانط غريب الأطوار، وخادمه الوفيّ. بيد أن الدهر قلب صفحته، واعتكر ما بينهما. واختلفت الروايات في السبب: أكانت جريرةَ سُكرٍ أم خيانةً بالسرقة؟ غير أن الشاهد أن كانط اضطر إلى صرف لامبه، وكان ذلك عليه كالفاجعة التي تُزلزل الوجدان وتُصدّع الروح.
فمن عاش في ظلّ إنسان أربعين عامًا، وخالطه في يقظته ومنامه، فقد ذاق في قربه طَعم الأُنس، ووجد فيه سكينة الصحبة؛ فكان الفراق طلاقَ روحين بعد طول أُنس وائتلاف. فكتب كانط فوق مكتبه رقعةً تقول: "انسَ لامبه!" يستحضرها في ذهنه كل صباح. بطبيعة الحال، يبدو هذا ضربًا من العبث؛ إذ كيف للمرء أن يُجبر نفسه على النسيان؟ فكلّما أجهدها في محو الذكرى، ألحّت عليه وأبت إلا الحضور. غير أن الإنسان، وإن عجز عن محو الذاكرة، فبيده أن يمنع نفسه من سكب تفاصيلها على حاضره، أو من اجترارها كما يُجترّ الألم. وهنا تحديدًا يكمن جوهر السؤال: هل يجدر بكانط أن يُلقي ذكرى لامبه في غياهب النسيان؟ أم يحتضنها بصفتها جزءًا لا يتجزّأ من كيانه؟
وللإجابة، سنتأمل رأيين متباينين كلّ التباين.
الأول لفريدريك نيتشه، الذي يرى أن النسيان، في بعض الأحايين، فعلٌ خلّاق، يُعيد الإنسان به صوغ نفسه، ويتحرّر من ربقة ما فات.
أما الثاني، فصوت إدموند بيرك، الذي يذهب إلى رأي غريب، وربما صادم: إنّ استعادة الماضي قد تكون تجربةً جمالية في ذاتها، تستحقّ أن تُعاش.
نيتشه والخلاص في حياة عالم الوحوش
لدى الفلاسفة علاقة عجيبة بالحيوانات، تنطوي على مزيج من الرأفة والتأمّل، بل وأحيانًا الحسد. فبعضهم، كجون ستيوارت مِل، يرى فيها موضعًا للشفقة. حين كتب: "خيرٌ للإنسان أن يعيش في تعاسةٍ من أن يغدو خنزيرًا راضيًا" كان يجادل بأن الذكاء البشري وما ينطوي عليه من ملكاتٍ عليا هو ما يُخوّل الإنسان بلوغ السعادة القصوى، حتى وإن تخلّلتها المعاناة. غير أن نيتشه، وكان معاصرًا له تقريبًا، سلك مسارًا مضادًا تمامًا. إذ كتب:
"تأمّل القطيعَ الهائم في المرعى بجوارك.
إنه لا يعلم من الأمس ولا من اليوم شيئًا.
يَقْفِز، يأكل، يستريح، يهضم، ثم يثب من جديد، وهكذا من الصباح إلى المساء، ومن يوم إلى يوم، لا يربطه بما مضى حزنٌ، ولا بما يأتي قلق، إذ كلُّ رغباته ونفوره مشدودة إلى وتد اللحظة.
ولذلك، لا يعرف الكآبة، ولا يتملّكه السأم.
إنّ مشاهدة هذا المشهد لأمرٌ شاقّ على الإنسان،
لأنه يفاخر بنفسه ويزعم أنّ جنسه البشري أرقى من جنس الحيوان،
ومع ذلك، ينظر إلى سعادة الحيوان بعينٍ ملؤها الحسد."
تكمن في الكائنات البهيمية نزعةٌ فطرية إلى معايشة اللحظة؛ فهي لا تشغل بالها بالماضي، ولا تُحمّل ذاكرتها ما لا طاقة لها به من عثرات الأمس، بل تمضي قُدُمًا كما لو أن الزمن لا يدور إلا في اتجاهٍ واحد. لا ينوء الحيوان تحت "العبء الخفيّ والمظلم" الذي يُثقل كاهل الإنسان، بل يحيا — كما عبّر نيتشه — حياة "لا تاريخيّة".
بالتأكيد، لا يمكن للمرء أن يحيا حياةً ذات معنى دون أن يستذكر شيئًا من ماضيه، ولو بدرجة يسيرة. الأبقار، مثلًا، قد تقضي يومها في اجترار العشب، راضية مطمئنة. إلا أن الإنسان ليس بقرة — ولا يمكنه أن يكون كذلك. من هنا، يُقدّم نيتشه نوعًا من إعادة التهيئة الذهنية، تُشبه في روحها استراتيجيات "المساعدة الذاتية"، قائلًا:
"انظر إلى الماضي كمعدنٍ تُستخرج كنوزه، لا كقيدٍ تُسلسل به."
لديك مكتبةٌ كاملة من الذكريات. بعضها جراح، وبعضها أفراح. منها ما هو تافهٌ لا وزن له، ومنها ما يغور عميقًا في صميم ذاتك، لا يكاد يُفارقك. بالنسبة لنيتشه، لا تُؤخذ الذكريات على عواهنها، بل ينبغي أن نُصادرها من الماضي، وأن ننتقي منها ما يصلح، ونجعل منه أثيرًا للحياة.
وإن كان ما في الماضي سُمًّا يُوهِنك، فانصرف عنه، وامضِ في دربك.
بيرك والجمال في تأمّل صدمات الماضي
قبل قرنٍ من نيتشه تقريبًا، يُقدِّم الفيلسوف الأنغلو-إيرلندي إدموند بُورك تأمّلًا من نوعٍ آخر: ماذا لو كانت في تذكّر الصدمة متعةٌ جمالية؟
فلدى بُورك، يرتبط ما يُسمّى بـ"المهيب" بتجربةٍ جمالية لا تُشبه اللذة، بل هي "رُعبٌ محبّب إلى النفس، وسكينةٌ مخضّبة بالذُّعر."
إنّه شعورٌ عنيف، متّصل بغريزة البقاء، ولذلك يُعدّ من أقوى المشاعر التي تكتسح النفس.
تتجلّى لحظة الشعور بالمهيب عند وقوفك عند أقدام شلّالٍ هادر، أو وسط عاصفةٍ رعديّة، أو عند سماع هتاف الجماهير في استاد كرة قدم، أو في لحظة التحديق في عدد لا يُحصى من نجوم السماء ليلًا.
إنه تقديرٌ للجمال المهيب من موقعٍ آمن.
وتُعدّ التجارب الصادمة، وماضينا المتكسّر، بطبيعتها، أشياء فظيعة، مزلزِلة، بل مُهلكة. لكنها اليوم تنتمي إلى زمنٍ مضى، فلم تَعُد، في ذاتها، تهديدًا مباشرًا، بل غدت شيئًا نُشاهد أثره.
وعندما نتذكّر تلك اللحظات، ونُحدّق فيها، نقع في لحظة الشعور بالمهيب.
حين ننبش الجراح، ونتذوّق ملوحة الذاكرة، لا لنُشفى، بل لنستمتع — استمتاعًا ماسوشيًّا — بتلك اللذّة الجمالية الكامنة في الرهبة.
وليس هذا أمرًا جديدًا؛ فقد تطرّق إليه الفلاسفة منذ القِدَم، وتبناه فرويد أيضًا.
لكن بورك يُقدّمه من زاويةٍ فريدة: فهو لا يرى ماضينا خطرًا، ولا حكمة، بل قطعةً فنية في متحف، نقف أمامها، نُمعن النظر، ونقول: "يا له من شيءٍ مروّع... لكنه جميل."
وربّما لهذا السبب نستمرّ في التنقيب داخل ذاكرتنا، لا لنُغيّر الحاضر، بل لأن في التحديق في الكارثة متعةً خفيّة: متعة مجالسة الخوف، وملامسة الجمال.
أَنُحاور الماضي أم نتجاوزه بالصمت؟
في نهاية المطاف، أرى أن نصيحة نيتشه صائبة. فهي تُختصر في قولين:
"إن كان النسيان يُصلحك، فانسَ، وإن كانت الذكرى تُقوّيك، فاستحضرها."
لا تنطبق هذه القاعدة على التجارب الوجودية الكبرى فحسب، بل تمتدّ إلى أنشطة الحياة اليومية البسيطة، مثل: كتابة اليوميات، أو الحديث مع الأصدقاء، أو حتى الجلوس في جلسات العلاج النفسي.
ومن حيث التجارب الشائعة، يبدو أن العلاج النفسي يؤتي ثماره — فجلّ من خاضوه أو خرجوا منه، يقولون إنه تجربة نافعة، بل صحيّة ومُثرية.
لكن ينبغي أن يُؤخذ رأي نيتشه بالحسبان هنا أيضًا. فبعد ستة أشهر، أو سنة، أو أيّ مدّة يراها المرء كافية، يجدر به أن يسأل نفسه:
"هل صرتُ إنسانًا أفضل؟"
إن كانت الإجابة نعم، فامضِ قُدمًا. وإن لم تكن، فربّما آن أوان النسيان.